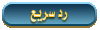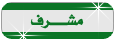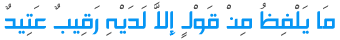تمهيد:تعتبر البيئة التي شهدت ختم النبوة ذات
دلالة هامة حول علاقة الرسالة بالواقع والسياق الجغرافي والتاريخي الذي
بدأت فيه، كما أن معرفتها مهمة في فهم طبيعة الرسالة الخاتمة وخصائصها،
والإلمام بهذه البيئة يكتنفه الكثير من الصعوبات والغموض , لاسيما فيما يخص
الواقع الديني الذي كان سائداً آنذاك، إذ المراجع التاريخية حول هذه
المرحلة وفي الجانب الديني بالخصوص قليلة جداً، وما وجد منها لا يفيد في
الموضوع , إلا إشارات ودلالات عامة لا تفسر العقلية والتفكير الديني الذي
كان سائداً , بخلاف مناطق ومراحل تاريخية أخرى , إذ توجد حولها نصوص ونقوش
مفصلة أحياناً، وهذا ما عانى منه مختلف المؤرخين الذين اشتغلوا في
الموضوع(1) .
أما النص القرآني فأسلوبه بشكل عام يبتعد عن التفصيل
في المواضيع التاريخية , إذ يأتي بذكرها لتحقيق هدف خاص هو العبرة والنقد
والتوجيه نحو المستقبل , واكتشاف السنة الإلهية، لذلك فهو غير صريح في
الدلالة على ما كان سائداً، لكن ما ورد فيه من نقد متواتر لما كان سائداً
من عادات وتقاليد وأفكار يمكن أن يكون مرجعاً غير مباشر لاكتشاف تلك البيئة
المثيرة(2) .
وهذا ما سنتتبعه في هذه المقاربة مستأنسين ببعض ما
ورد في الدراسات التاريخية المتخصصة في تلك المرحلة، وقد لوحظ أن القرآن
يقدم عن الدين الجاهلي صورة تختلف تماماً عما تقدمه كتب التاريخ والأدب(3) ،
لاسيما وأن تلك المصادر سعت إلى تقليل شأن عصر النبي وبيئته قبل البعثة من
الناحية المادية والأدبية , والمدارك العقلية حيث تصفها بصفات الجهل
والانحطاط والغلظة..، وهي نظرة تخالف ما تلهمه نصوص القرآن عن تلك
الفترة(4) .
المجتمع بين البدو والحضر:من
الصعوبات التي نود أن نشير إليها والتي لم يسعف فيها النص القرآني ولا
الدراسات التاريخية الخلط في المصادر بين البيئة الحضرية المكية التي بعث
فيها الرسول وبين عادات وتقاليد أهل البدو والمناطق غير الحضرية، فما ورد
عن العرب في الجزيرة العربية يتم تداوله مجملاً من غير تفصيل(5) ، فهل ما
ورد كان خاصاً بأهل مكة من العرب , أم يشمل ما جاورهم في أصقاع الجزيرة
العربية من بواد وحواضر أخرى غير مكة وهي غير قليلة وعلى صلة مباشرة بأهل
مكة، وما يدعو إلى إثارة هذا التساؤل ما يمكن ملاحظته من تناقض في
العادات(6) ، والقيم الواردة عنهم مجملة دون تفصيل، بل إن بعض المستشرقين
شكك في مدينة مكة باعتبارها محطة للقوافل(7) .
وإذا تأملنا في
القرآن نجد إشارات خاصة إلى الأعراب(8) الذين يكونون عادة حول القرى(9)،
وبينت الآيات بعض أخلاقهم وعاداتهم وكيفية تعاملهم مع الرسول مشيرة إلى
كونهم أشد كفراً وغلظة من أهل الحضر(10) ، مما يدل على تفاوت في قيم
التعامل مع الرسالة بين أهل القرى وأهل البادية، كما أن الأعراب أنفسهم
-كما تشير الآيات - لم يكونوا على درجة واحدة في تلقي الرسالة وتعاملهم
معها(11) ، ومما يلح على ضرورة التمييز بين البدو الحضر هو ظاهرة تعميم حال
البدو الرُّحَّل , واعتبارهم مقياساً للثقافة العربية فيما قبل
الإسلام(12) .
لكن بعض الباحثين لاحظ ضرورة إعادة الاعتبار للقرشيين
الذين كانوا أكثر وعياً وذكاء وإنسانية من الجموع البدوية، وأنه كانت لهم
قدرات أخلاقية وفكرية استثنائية، لا يستبعد أنها تكرست عبر تحول الشخصية
لأناس كانوا بدواً في الماضي , وذلك بفضل الاستقرار الذي ساعد عليه توطد
التجارة في مكة(13)
وأن هذا الوضع الجديد للقرشيين في مكة أدى إلى
دخول قيم جديدة بفضل الثروة , ومن هذه القيم النزعة الفردية , وروح
المنافسة مقابل المثل الجماعية التي كانت طاغية , ويحاول هذا التفسير إبراز
حاجة المجتمع إلى قيم جديدة تحافظ على القبيلة(14) .
أياً يكن
الأمر فيما يخص الاختلاف بين أهل القرى وأهل البادية وما كان سائداً بين كل
من نظُمٍ وقيمٍ، فإن من ميزات الإسلام أنه استطاع صهر المجموعات البدوية
والحضرية في نسق واحد ووجههم في خط الرسالة(15) ، والأهم هو فهم هذا المنهج
القرآني من خلال الأفكار التي نقدها القرآن مجملة من غير تفصيل بيئتها
وخلفيتها وأصحابها، كما هو الشأن في الكثير من القصص القرآني.
فما
لم يكن التاريخ مؤثراً في العبرة والدلالة يهمل، والذي يمكن تلمسه من خلال
هذا العموم القرآني في الحديث عما كان سائداً قبل البعثة هو الثراء والتنوع
والتناقض في القيم والأديان والعادات التي كانت سائدة قبل البعثة، حتى
اعتبرت الجزيرة العربية مختزلة لأديان ومعتقدات العالم السماوي منها
والأرضي(16) .
وفي هذا الإطلاق والتنوع في بيئة جغرافية مركزية تشهد
حركية منقطعة النظير بين مختلف المناطق من العالم دلالة على الحكمة من كون
الرسالة الخاتمة تنطلق من هذه البيئة إلى العالم ,إذ ستأخذ طابع البيئة
التي انطلقت منها وهو العالمية، وهذا ما يدعونا إلى اكتشاف مكة في عصر ما
قبل البعثة , وما أهَّلها لاحتضان مبعث النبوة الخاتمة .
مكة قبل البعثة:إذا
ذكرت مكة تعود الذاكرة إلى إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- ورفعهما
القواعد من البيت , ونداء إبراهيم في الناس بالحج، ودعاء إبراهيم لأهل هذا
البيت(17) ، وفي هذه الإشارة والعلاقة بين إسماعيل وذريته والبيت الحرام
دلالة على التقابل مع إسحق , وتوالي الأنبياء من ذريته، فكانت ذرية إبراهيم
قد شرفت بالتاريخ الرسالي والجغرافية المقدسة والمحرمة، فلئن اختص نسل
إسحق بالأنبياء فإن نسل إسماعيل ارتبط بالمكان الذي أصبح مركزاً ومآلاً
للرسالات التي ختمت به ؛ لتنطلق إلى العالم بصيغة نهائية تناسب الكونية
التي غدت تحتلها مكة وبيتها الحرام، أول بيت وضع للناس(18) ، الذي سيصبح
مركز التاريخ الإنساني(19) .
هذه المركزية والعمق التاريخي لمكة الذي يشير إليه القرآن يدعو لمعرفة أحوالها , وذلك لفهم الأساس الذي قام عليه الإسلام(20) .
يطلق
القرآن على مكة اسم أم القرى(21) مما يحمل دلالة على محوريتها بين القرى
الأخرى التي ترجع إليها , وتقلدها كعاصمة توجه المنطقة(22) ، فموقفها من أي
قضية يؤثر بموقف المناطق الأخرى حتى إذا فتحت ودانت بالإسلام تبعها
الناس(23) ، ومما لا يحتاج إلى تأكيد أن وجود الكعبة ومناسك الحج فيها كان
العامل الأكبر في مكانة مكة , والمركز المعنوي الذي تتمتع به(24) .
إضافة
إلى ما كانت تتمتع به من حركية تجارية بفضل موقعها على الطريق التجاري
البري بين اليمن وبلاد الهلال الخصيب، وممارسة أهلها للتجارة مع مختلف بقاع
العالم براً وبحراً، وكذلك المهن المرتبطة بالتجارة(25) ، والقرآن يحفل
بالآيات الدالة على ذلك .
فالقرآن يستعمل تعابير مالية وتجارية لا
بد كانت مفهومة ومتداولة مثل: الحساب والميزان والقسطاس والذرة والمثقال
والقرض، كما ذُكرت السفن والجواري والمنشآت في البحر، وتردد فيه ذكر تجارة
البحر، كما كانت ظاهرة الاستثمار بالربا والقرض ظاهرة منتشرة كما تدل آيات
الربا في القرآن، وسورة قريش(26) واضحة الدلالة على الرحلات التجارية
البرية , وما كان يعقد فيها من اتفاقيات وعلاقات، والسور المكية تحفل بما
يدل على ثرواتهم الطائلة(27) .
كما أن عاداتهم في استقبال القوافل
التجارية بقيت مستمرة لما بعد الإسلام(28) ، كل ذلك يدل على المكانة
التجارية التي كانت تحتلها مكة قبل البعثة، ويستتبع هذه المكانة مستوى من
الوعي الضروري الذي أهَّلهم للقيام بهذا الدور.
هذا والمكانة
الدينية التي تحتلها مكة منذ القديم(29) هي العامل الأساسي في نجاحها
التجاري , إذ شكل موسم الحج فيها سوقاً تجارياً سنوياً، والأهم من ذلك ما
وفره الحرم من أمن لمكة , تلك المدينة التي لا تمتلك عوامل الأمن الطبيعية
فجاء أمنها من قدسيتها واحترامها عند الناس, وقد أشار القرآن إلى هذا
الجانب في قوله تعالى : " وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعْ الْهُدَى مَعَكَ
نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا , أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا
وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ " [القصص:57].
بل هناك
آية قرآنية صريحة في كثرة خيراته , وهي"يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ
شَيْءٍ" وقد أشار اللَّهُإلى العلاقة بين الكعبة وموسم الحج وبين التجارة
التي فيها قوام الحياة في قوله تعالى : "جعل الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْقَلائِدَ" [المائدة:97](30).
قدسية مكة ومكانتها هذه فرضت بعض
الوظائف الدينية والاجتماعية لدى أهل مكة الذين شرفوا بها، وهي وظائف
متداخلة، فهي اجتماعية باعتبار علاقة الأقوام والقبائل بها , ودينية من حيث
ارتباطها بالبيت الحرام ورعايته، ومن هذه الوظائف التي أشار القرآن إلى
قيامهم بها: النسيء وهو تحديد مواعيد الأشهر الحرم من كل عام بما يتناسب مع
مصالحهم(31) ، والسقاية وعمارة المسجد الحرام ورعايته(32) .
هذه
الصورة العامة لواقع مدينة مكة تدل على كونها مدينة تمتلك من مقومات النظام
ما يؤهلها لقيادة ما حولها من الحواضر، بل وتنظيم العلاقات واللقاءات بين
مختلف القبائل والوفود القادمة إليها، ولئن كان غامضاً طبيعة النظام الذي
كان سائداً فإن هناك إشارات قرآنية عديدة إلى بعض الآليات التي كانت سائدة
في إدارة مكة وقيادتها، من ذلك ظاهرة النوادي التي كان يجتمع فيها الناس
ويتداولون الشأن العام , وقد أشار القرآن إلى ذلك(33) .
إضافة إلى
العديد من المفردات التي تم تداولها في القرآن , والتي تدل على وجود ملامح
الشوكة والسلطة والحكم في تلك البيئة، من ذلك: الجند، الإثبات والإخراج من
مكة، الملأ، الحبس، السجن، أولو الأمر.. ، كل هذه المفردات تدل على مفهوم
السلطة , وقد استعملت في آيات مكية، ومنها ما هو مباشر يخص أهل مكة , ومنها
ما يدل السياق على علمهم بمضمونها ومعانيها(34) .
ونفس الأمر
بالنسبة للقضاء فهناك آيات ومصطلحات – أبرزها مفردة الحكم ومشتقاتها- تدل
على وجود نمط من السلطة القضائية تحل النزاعات بين الناس، وكانت تستند إلى
التقليد والعرف، ويقوم بها الوجهاء، وتتم بالاختيار(35) .
هذا عن
المعالم العامة لمكة قبل البعثة، أما الشرائح السكانية التي كانت تقطن في
مكة فهناك آية تشير إلى وجود بعض الأجانب إلى جانب العرب(36) ، لكن هناك
آيات مكية كثيرة(37) تدل على وجود جالية لا بأس بها من أهل الكتاب يعيشون
مع العرب في مكة وأكثرهم من النصارى وفيها بعض اليهود(38) .
أما
جذور وتاريخ اليهود في الجزيرة العربية فليس هناك من النصوص التاريخية ما
يتحدث عن وجودهم قبل الميلاد , أما بعده فقد ثبتت هجرتهم إلى الحجاز إثر
ظهور الروم على بلاد الشام وفتكهم بالعبرانيين(39) ، أما النصرانية فقد
دخلت الحجاز عن طريق التبشير والنساك والرهبان الذين قدموا إليها(40) .
وقد
دخل بعض العرب في النصرانية , أما اليهود فقد كانوا أقلية في مكة ,
وانتشروا في المدينة أكثر , ويدل الخطاب القرآني لهم بـ ( بني إسرائيل )
على الإطلاق على الصلة بين معاصري عصر الرسول وأسلافهم وعلى كونهم طارئين
على الحجاز , وأنهم غير عرب(41) .
هذه الجالية الأجنبية المقيمة
بمكة بما تحمله من أفكار وعادات، إضافة إلى الوفود السنوية من مختلف
المناطق التي تفد إلى مكة في موسم الحج أو القوافل التجارية التي تمر عبر
طريقها، كل ذلك سيكون له دوره في التلاقح الفكري الذي من الطبيعي أن يكون
له أثره في أفكار وربما عقائد المكيين، وفضلاً عن هذا الجانب فإن لحضور هذه
الجاليات دلالة على كون مكة فضاء مفتوحاً , وكون المكيين على إحاطة بما
يجري في العالم , وعلى اتصال دائم بما حولهم، كل هذه المعطيات تؤكد المكانة
الحضارية التي كانت تمتاز بها مكة مما أهلها لاحتضان الرسالة الخاتمة التي
ستنطلق إلى العالم المختزل في عالم مكة الأرخبيلي.
لكن المحور
الأهم في حياة المكيين هو الأفكار والعقائد التي كانت سائدة قبل البعثة،
ولئن كان القرآن المكي يشتمل على بيانها فإن السياق القرآني يعالج هذه
الأفكار خارج إطار الزمان والمكان، وليس من الضروري أن تكون الأفكار
المطروحة للنقد هي أفكار أهل مكة باعتبار أن الدعوة كانت تنطلق إلى جميع
الناس , حتى الوفود الذين يردون إلى مكة أو القاطنين خارجها، مما يقتضي
اتباع السياق القرآني , وتناول تلك الأفكار خارج السياق التاريخي
والجغرافي، ويؤكد أهمية ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من تداخل أفكار أهل البدو
مع أهل الحضر دون تمييز.
لهذه الاعتبارات سنتناول الأفكار والعقائد
التي كانت سائدة قبل البعثة , والتي يشير إليها القرآن , وذلك بغض النظر
عمن كان يتبناها ، والمكان والتاريخ الذي كانت منتشرة فيه، المهم حضورها في
عصر الرسول.
الأفكار والعقائد/ البيئة الدينية والفكرية قبل البعثة:يحتل
المجتمع الجاهلي مساحة كبيرة من آيات القرآن , إذ بلغت الآيات التي
تناولته /1575/آية، منها /1096/آية مكية و/479/آية مدنية، وتشكل عقائد
المجتمع الجاهلي نسبة 54% من الآيات، ومعظمها مكي، وقد توزعت القضايا
العقدية فيها على ثلاثة محاور: الشرك=514، البعث=282، إنكار الوحي=69 .
هذه
المعطيات العددية إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية تلك المرحلة ,
وضرورة معرفتها لما لها من أثر في تصور الإضافة التي جاءت بها الرسالة
الخاتمة، والتركيز القرآني على مجموعة من العقائد المركزية , يشير إلى
أهميتها في مضمون الرسالة الجديدة.
سنحاول استكشاف المحاور الرئيسية
للأفكار والعقائد التي كانت سائدة مستلهمين ذلك من آيات القرآن مع الإحالة
على أماكن تفصيلها في كتب اختصت بالموضوع، وسنركز على ثلاثة محاور :
الأفكار والعادات العامة , وسنجمل فيها ما ساد من عادات وتقاليد اجتماعية
أو سياسية أو اقتصادية بشكل عام، ثم نثني بالعقائد الدينية التي كانت سائدة
, ونتبع ذلك بالطقوس الدينية المنتشرة .
1-
الأفكار والعادات العامة :يوصف
المجتمع الذي سبق البعثة بالجاهلية , وهو وصف وارد في القرآن على بعض
الجوانب في ذلك المجتمع(43) ، فهو وصف نسبي ينطبق على الجانب العقدي وما
يرتبط به , وبعض العادات الاجتماعية , ولا تصح هذه التسمية من الناحية
الثقافية(44) ، فلم يكن مجتمع ما قبل البعثة كما تصوره الكثير من المصادر
مجتمعاً معزولاً عن العالم , أو لا يعرف من العلوم شيئاً بل العكس، إذ كان
لدى العرب أدب ولغة في غاية التطور، وكانت لديهم معارف بالأنساب والتاريخ
والفلك، فضلاً عما تقتضيه الحركة التجارية التي كانت سائدة في المنطقة من
علم بالاقتصاد والحساب والكتابة، والدلائل كثيرة على إلمام العرب بالقراءة
والكتابة وانتشارها بينهم(45) .
هذا التقدم الحضري الذي سبق البعثة
يذكرنا بالبيئات التي بعث بها الرسل من قبل , والتي كانت تتميز بكونها
مجتمعات حضرية متقدمة , وربما بلغت شأواً في العلم والتقدم المادي، هذا
الجانب المادي عندما يطغى على الجانب الأخلاقي يسود الظلم , ويصل بالمجتمع
إلى مأزق روحي، فيأتي التدخل الإلهي عبر إرسال الأنبياء لتصحيح مسيرة الناس
, وردهم إلى فطرتهم , والإيمان بالله الذي يقتضي العدل , وإعارة الجانب
الروحي من حياة الإنسان حقه، فالتقدم المادي لا يستلزم رقياً دينياً أو
روحياً , بل ربما كان عائقاً أمام انتشار القيم والمثل التي يحافظ عليها
قلة في المجتمع، وهذا ما كان عليه حال المجتمع الذي سبق بعثة الرسول .
فمن
العادات الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك العصر التمييز ضد المرأة
المتمثل في مختلف الجوانب المتعلقة بها من طرق النكاح والطلاق إلى الإرث
والوأد، وإن كانت هناك شريحة من النساء في نفس المجتمع تأخذ دوراً
اجتماعياً متميزاً ينافس الرجل كالتجارة , والمشاركة في الدفاع عن المجتمع
وقيمه، وقد حكى القرآن مناهضة نماذج من نساء ذلك العصر الدعوةَ الجديدة
وإيذائهن الرسول(46) .
وهذا التفاوت في دور المرأة المتراوح بين
كونها سبَّة وعاراً ومتاعاً , وبين ممارستها لدور قيادي في المجتمع يحمل
إحدى دلالتين: إما تنوع الموقف من المرأة واختلافه بين الحضر والبدو , أو
بين القبائل , أو بين المناطق , أو بين أصناف من النساء في المجتمع الواحد ,
وقد حكى القرآن جميع الصور التي كانت موجودة بإجمال دون تفصيل , مع
تقويمها وتصحيحها , ودعم ما هو صواب وإيجابي منها.
والدلالة الثانية
المحتملة أن المرأة كانت تتعامل مع تلك القيم التي تضطهدها على أنها أمر
واقع وقانون اجتماعي ينبغي الرضا به وقبوله دون أن يمنعها من ممارسة دور ما
يسمح به المجتمع، وهذه العادات المتعلقة بالأحوال الشخصية والعلاقة مع
المرأة إنما هي عادات اجتماعية لا ترتبط بالدين الجاهلي إلا في بعض الجوانب
منها , سنشير إليها لاحقاً.
الجانب الآخر الذي كان سائداً من
العادات , والذي كان يحمل أكثر من وجه من الناحية القيمية هو ظاهرة الولاء
والعصبية بين أفراد القبيلة ومن يدخل في حلفهم، وكان هذا الجانب يمثل رابطة
العقد السياسي الذي ينظم المجتمع , ويقوده ويضمن فيه الأمن والحفاظ على
الحوزة ووحدة القبيلة، وقد أورثت هذه العادة بعض الجوانب الإيجابية التي
استثمرها الإسلام ورعاها مثل: التآلف والتآزر ومساعدة الضعيف والجوار ..
لكن
الجانب الخطير لهذه العادات هو ما تورثه العصبية العمياء من ظلم واعتداء
وسفك للدماء , وذلك بالثأر ومناصرة القبيلة , سواء كانت على حق أو باطل،
فجاء الإسلام يصحح هذه المظاهر ويقومها(47) .
إضافة إلى هذه العادات
كانت ظاهرة الطبقية والرق منتشرة عندهم، لكن العتق كان مكرمة يمتدح بها
ممارسوها , وقد حارب الإسلام هذه الظاهرة , وشجع على مكرمة العتق التي كانت
منتشرة كفضيلة بين الناس(48) .
هذه هي أهم العادات التي كانت
سائدة , أوردنا مجملها من غير تفصيل ؛لأن تفاصيلها كثيرة وما أحلنا عليه من
مراجع يغني عن التكرار, إنما أردنا الإشارة إلى الطابع المزدوج من الناحية
القيمية لهذه العادات، وكيف تعامل القرآن معها مستثمراً الإيجابي منها ,
ومصححاً للجانب المظلم منها، وهذا المسلك القرآني مع العادات سيتكرر مع
الجانب الديني الذي سنتناوله في الفقرة التالية .
- الفكر الديني قبل البعثة :تطالعنا
آيات القرآن بأسماء أديان كانت معروفة ومتداولة لها معتنقوها في ذلك العصر
وهم: اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والمشركون(49) ، وقد كان لهذه
الأديان حضور وتواصل بين أتباعها، مما يجعل من الطبيعي أن يكون بينهم حوار
وتأثر متبادل، وسنعرِّف بكل فريق منهم في إطاره الزماني والمكاني .
اليهود
والنصارى : أشرنا قبل قليل إلى وجود جالية من اليهود والنصارى في مكة،
وكان لهم حضور أكبر في المدينة، وقد اعتنق بعض العرب النصرانية، وكان
لبعضهم مكانة متميزة في المجتمع، وكانت تجري بينهم وبين المشركين حوارات
وجدل في قضايا مختلفة، وقد تأثر بهم العرب , وتعلموا منهم بعض الفنون
والقصص وأخبار الأنبياء والأمم الغابرة , فكان لعلمهم بالكتاب تميز على
العرب الذين كانوا ينتظرون نبياً يبعث فيهم , بينما كان أهل الكتاب يدَّعون
أن النبي سيبعث منهم(50) .
وكان لهم تأثير في أفكار العرب الدينية
لكن دون أن يتمكنوا من اكتساح الوثنية الجاهلية ؛ ففضلاً عن كون اليهودية
ديانة قومية لا تسعى لإدخال الناس فيها فإن أفكارها لا تناسب بيئة العربي
الذي يسعى للحصول على الغنائم من الحروب بينما تحرم اليهودية الانتفاع بها،
وكذلك المسيحية لم تكن لتقنع العربي الذي يحب الثأر أن يدير خده الأيسر
لمن ضربه على خده الأيمن كما تدعو المسيحية(51) .
المجوس: يقصد
الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، وقد وردت لفظة المجوس
في القرآن علَماً لدين(56) ، فدل على وقوف أهل الحجاز على خبرهم ومعرفتهم
بهم، ولا يستبعد وجود نفر منهم في مكة والمدينة والطائف وغيرها، ربما وجدوا
عن طريق التجارة أو الرقيق، ولم يرد دخول قبائل عربية في المجوسية , ولهذا
كان معظم مجوس جزيرة العرب من الفرس المقيمين في البحرين واليمن وعمان(57)
، ويروى أن المجوسية كانت في تميم(58) ، وأياً يكن الأمر ففي ذكرهم دلالة
على صلة العرب بالأديان الشرقية مما سيكون له أثر في أفكارهم وعقائدهم.
الصابئون:
ذُكِر الصابئون في القرآن ثلاث مرات، وقد اتجه معظم المفسرين إلى جعل
المقصود بهم ديانة الصابئة المختلف في عقائد أصحابها بين قائل إنهم من
المجوس أو إنهم عُبَّاد الملائكة أو الكواكب أو الشمس، أو إنهم فريق جمع
بين مختلف الأديان، ومن هذه العقائد ما طرأ بعد الإسلام(59) .
الحنفاء:
عرف الحنفاء بين المسلمين بأنهم من كانوا على دين إبراهيم من الجاهليين،
فلم يشركوا بربهم أحداً , ولم يدخلوا في يهودية ولا نصرانية، ولم يقبلوا
بعبادة الأصنام ديناً , بل سفهوا تلك العبادة والقائلين بها، وكانت لهم
عادات خاصة تميزوا بها، وعلى العموم فإن المصادر لا تساعد على رسم صورة
واضحة للحنفاء، فما ورد في القرآن يؤكد أنهم أولئك الذين رفضوا عبادة
الأصنام، فلم يكونوا من المشركين، بل كانوا يدينون بالتوحيد الخالص، وهو
فوق توحيد اليهود والنصارى، فلم يكونوا يهوداً ولا نصارى، وكان قدوتهم
إبراهيم.
الدين الجاهلي: من يتتبع ما ورد عن عقائد الجاهليين في
القرآن يجد أنها من التنوع والكثرة والاختلاف ما لا يحيط به اسم دين أو
عقيدة، وهي عقائد متشابهة في بعض الأشياء والرموز , ومختلفة في البعض
الآخر، لكن القرآن يورد مسمى واحداً يتكرر مع ذكر مختلف هذه العقائد , هو
مفردة الشرك ومشتقاتها، بحيث يمكن اعتبار هذه التسمية تعبيراً عن العقيدة
العامة التي كانت تسود في بيئة عصر البعثة، وأنها لا تعني نوعاً محدداً من
العقائد، وأنها كانت عامة يمكن أن ينطوي فيها عقائد متنوعة، وقد تكون
أحياناً مختلطة ومتداخلاً بعضها مع بعض، يجمع بينها ضابط عام هو إشراك ما
دون الله مع الله أياً كان هذا الدون(66) .
تصور الإله عند
الجاهليين : يحفل القرآن بذكر عدد من أسماء الآلهة الجاهلية التي كانت
منتشرة في مكة أو خارجها والتي كان يعبدها العرب، كما ورد ذكر الأصنام
والأوثان والأنصاب والأزلام وغيرها مما كان يعبده الجاهليون، ولم يقتصر أمر
الشرك على المصنوعات المادية فقد ذكر عبادتهم للملائكة والجن والشمس
والكواكب والدهر وغير ذلك(68) .
ولم تحدد جغرافية هذه الآلهة وأماكن
انتشارها وتاريخها إلا أنها تدل فيما تدل عليه من ورودها مجملة على التنوع
الذي كان سائداً، وربما يكون مرده حصول تطور في الفكر الديني العربي أدى
إلى الانتقال في تصور الإله من معبودات مادية إلى رؤية تجريدية، وذلك بفضل
الاحتكاك والتعرف على عقائد أهل الكتاب والبيئات المحيطة بهم.
الغيب عند
العرب :كان للفكر الكتابي دور في إدخال أفكار عن عالم الغيب في بيئة كانت
تعير المحسوسات أهمية في تفكيرها، لكن التطور الذي وصل إليه أصحاب هذه
البيئة لم يكن ليسمح بتبني تلك الأفكار كما هي , لاسيما ما يخص منها تصور
الله، ولعل المقارنة بين تصور النصارى لبنوة الإنسان لله وما تبناه
المشركون العرب من فكرة البنوة لله يشير إلى التأثر من جهة والمحاكمة من
جهة أخرى، فإذ أدرك الجاهليون وجود كائنات غيبية كالجن والملائكة , وهي في
تصورهم أقرب إلى الله من حيث طبيعة تصورها التجريدي، وكان الأنسب في
ذهنيتهم أن يكون اتخاذ الله للولد من الملائكة(72) .
هذا ولعالم
الجن دور هام في حياة العرب إذ كانوا في تصورهم هم مصدر التنبؤ والكهانة
والسحر والشعر، ونظراً لما يحتله من يمارس هذه الأشياء من مكانة فقد كانت
مصدر تنافس بين القبائل مما ساعد على انتشار هذه الظاهرة(83) ، وهذا الجانب
من الحياة العربية كان كأي جانب آخر عرضة للتطور والتغير، وما كان عليه
الحال قبل البعثة هو نتيجة لتطور مستمر دام آلاف السنين , قام به رجال من
أهل الجاهلية , إما بشعور ذاتي أو بتأثر خارجي من خلال الاتصال متعدد
الأشكال مع العالم الخارجي
خاتمة:هذه
التفاصيل القرآنية التي أوردناها حول المجتمع العربي قبل الإسلام لاسيما
فيما يخص الجانب الديني تدل على أن العرب لم يكونوا متفقين على عبادة موحدة
, ولم يكونوا يعبدون إلهاً واحداً أو أصناماً معينة , كما لم يكونوا
جميعاً على سوية واحدة في التفكير الديني، فلم يكن الانحطاط الديني عاماً
للجميع(104) ، فقد كانت الجزيرة العربية تمثل اختزالاً لما كان يسود الكون
من أفكار وأديان في العالم آنذاك , وذلك ما أهَّلها لتكون مهداً لرسالة
عالمية تخاطب العالم , وتخرج من وسط تجمُّع له صلة بما يسود الفكر الديني
في عصرها.
هذه المقاربة إن بدت موغلة في التاريخ فإن جوهرها وما
طرحته من رؤية حول تلك الفترة له صلة بحاضر العالم اليوم، فلئن ساد في
الفكر الإحيائي في القرن الماضي وصف العالم بالجاهلية، وبدا ذلك متناقضاً
من ناحيتين: المفارقة في المقارنة بين زمنين مختلفين ومفارقة مضمون
المفهوم، فإن ما تفيده مقاربتنا أن الإنسان أحوج ما يكون للدين عندما يكون
متقدماً وعالماً ومتطوراً، والأنبياء إنما كانوا يبعثون في بيئة حضرية
متقدمة، والقيم الأخلاقية يحتاجها الغني أكثر من الفقير , والقوي أكثر من
الضعيف.
لذلك فإن عالم اليوم المتقدم والدول المتعملقة على أكتاف
الضعفاء إنما تحتاج إلى بعث جديد يحيي فيها قيم الإنسانية التي جاء بها
الأنبياء , ويفتح أفق الإنسان لتصحيح التاريخ وتوجيهه نحو التي هي أقوم,
كما وجهته الرسالة الخاتمة عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى،
فتحول الكون إلى قرية اليوم يشبه أحوال مكة أم القرى عند البعثة , حيث
امتزاج الأفكار والأديان والأعراق ومحوريتها بين القرى.
ويبقى
التاريخ مصدراً حضارياً وملهماً أساسياً لمن يبتغي رؤية المستقبل رؤية
بعيدة، فحاضر اليوم "وَلَنْ تَجِد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً " ليس إلا
نتيجة ما فعل بالأمس , والغد ليس إلا نتيجة ما نفعله اليوم.





 الخميس 25 أبريل 2013 - 19:22
الخميس 25 أبريل 2013 - 19:22